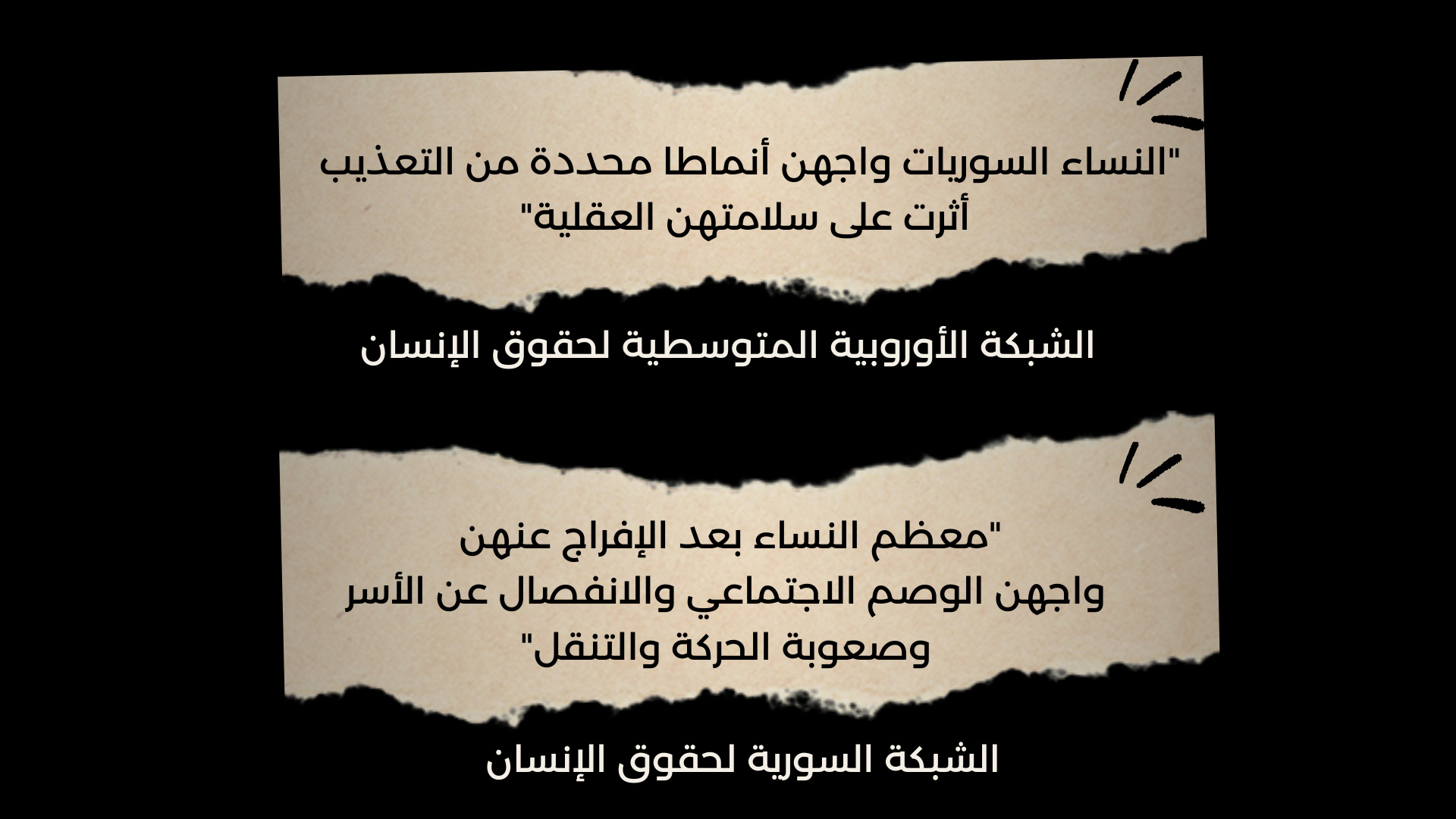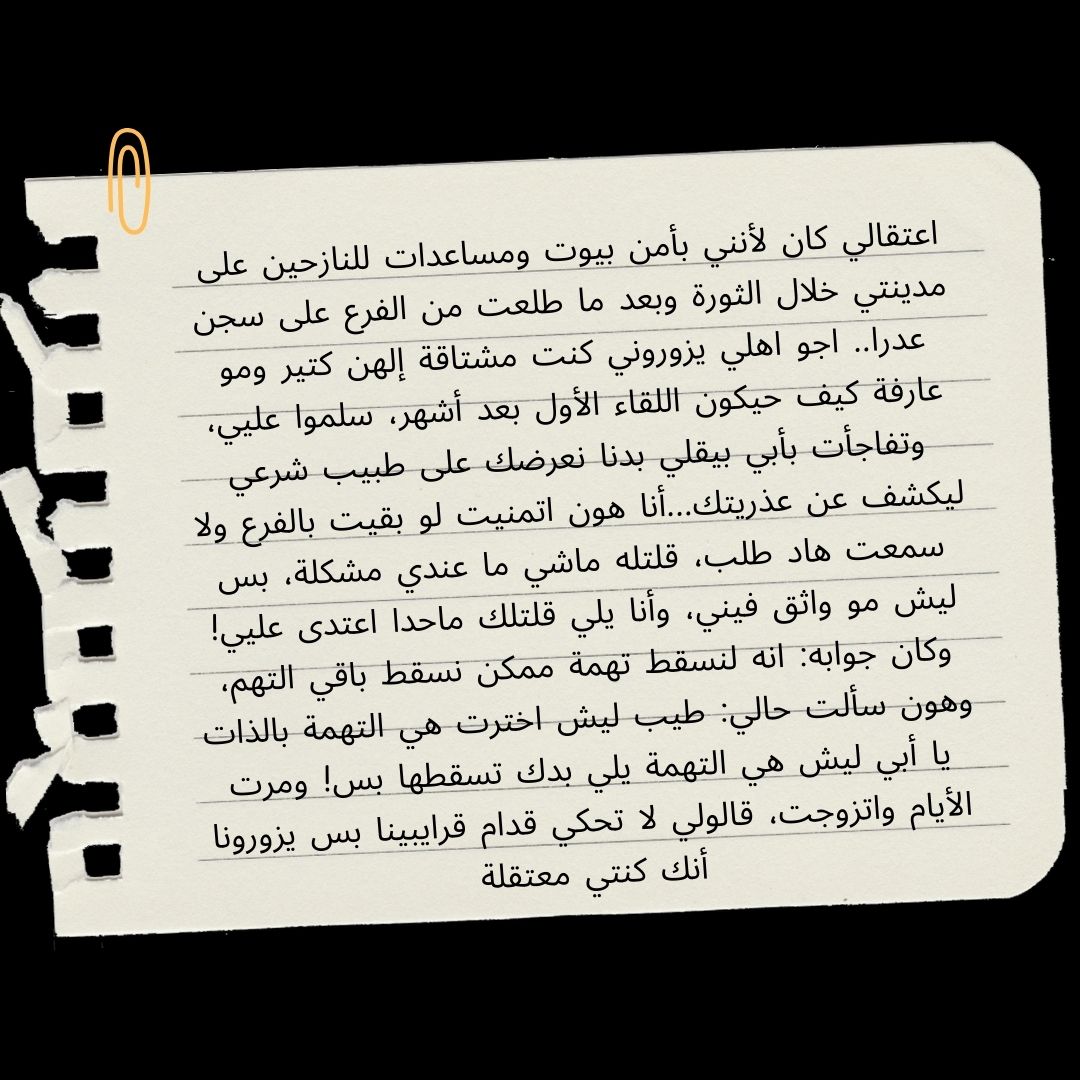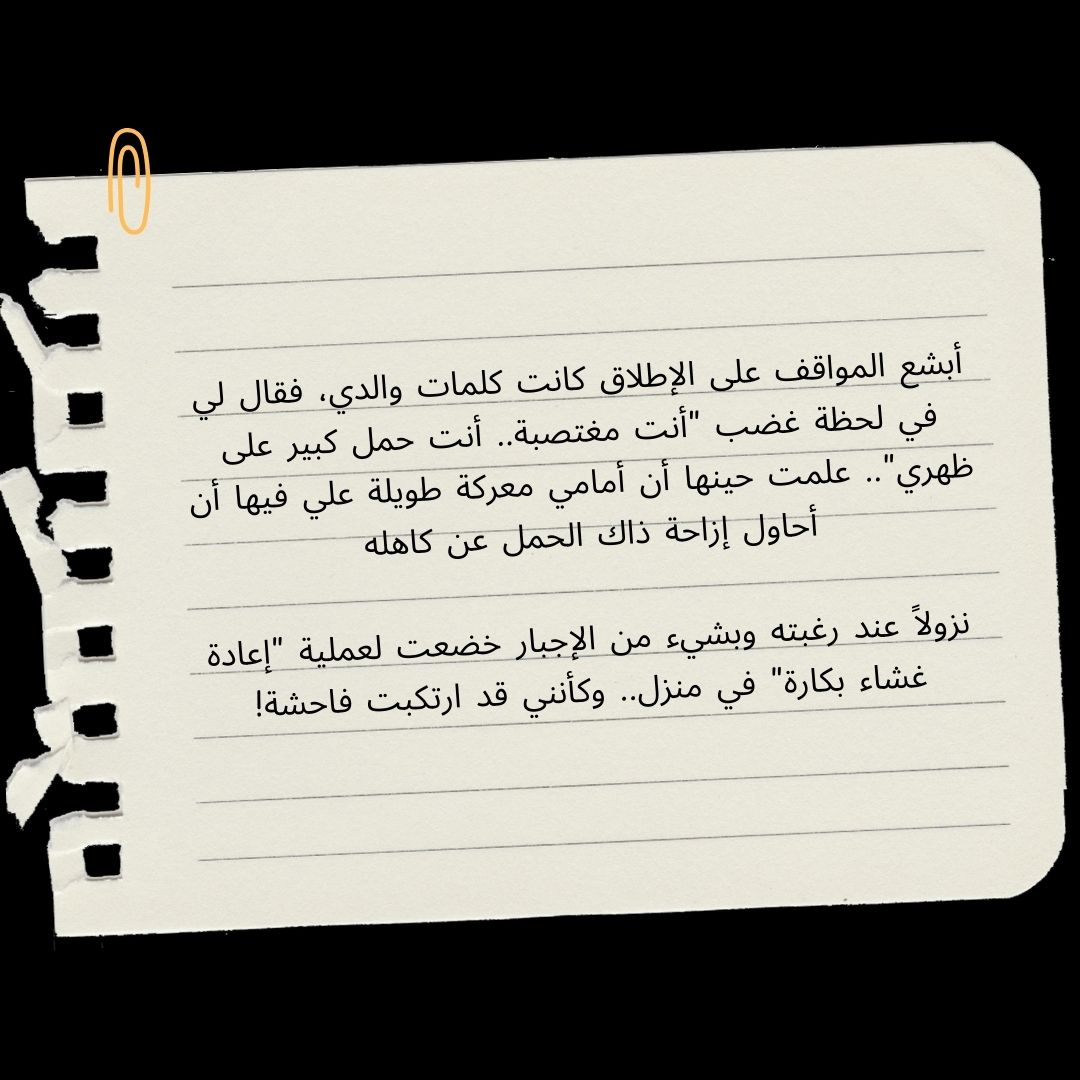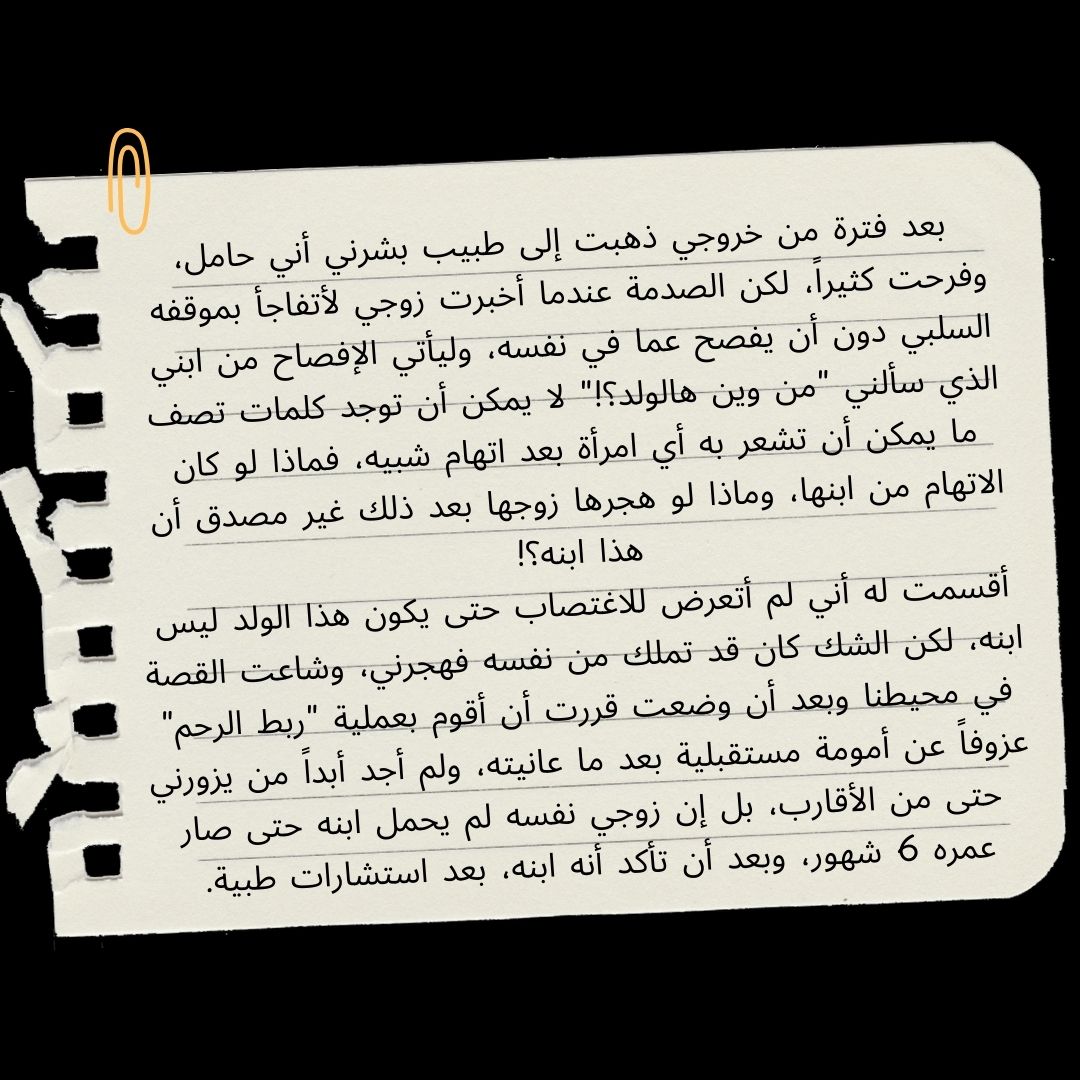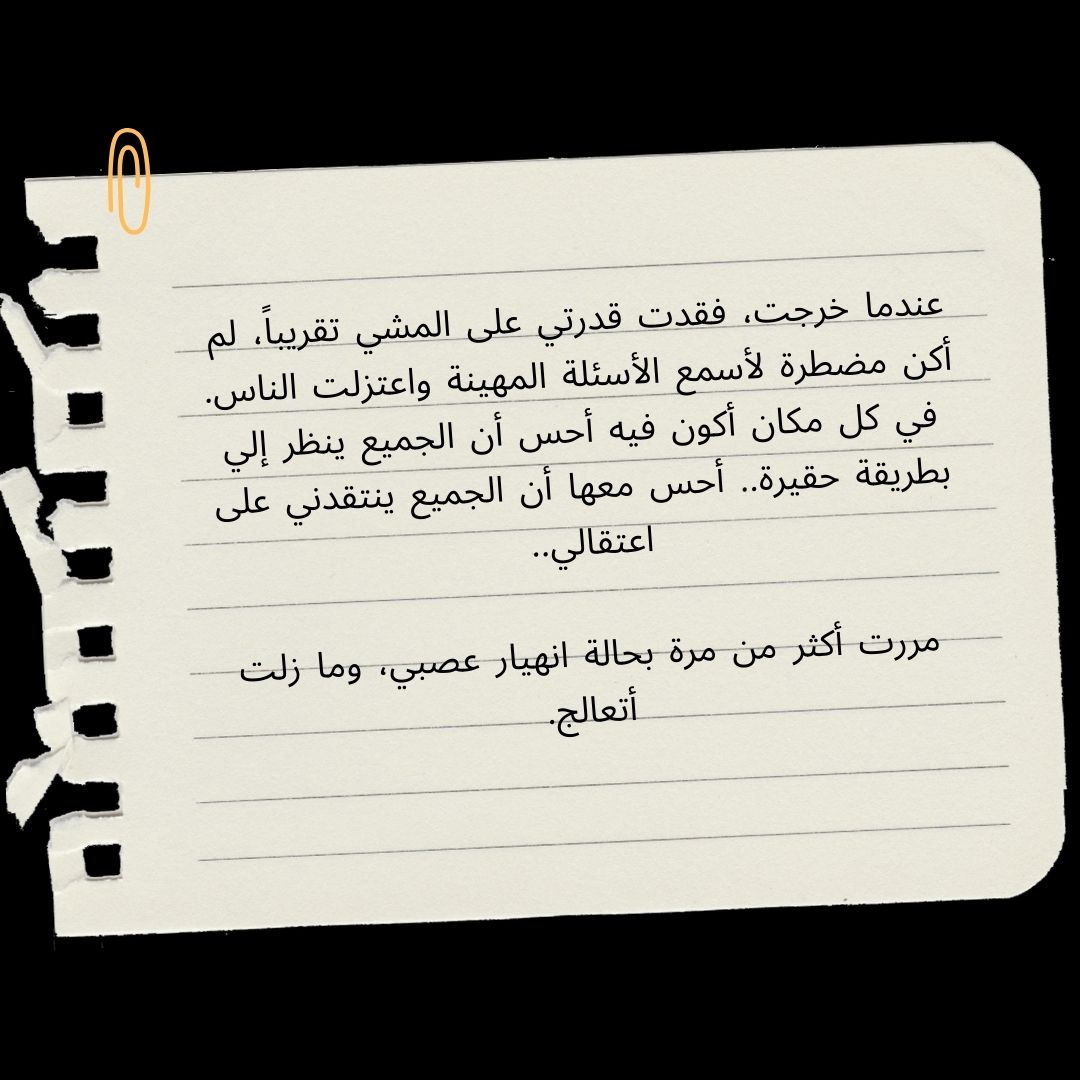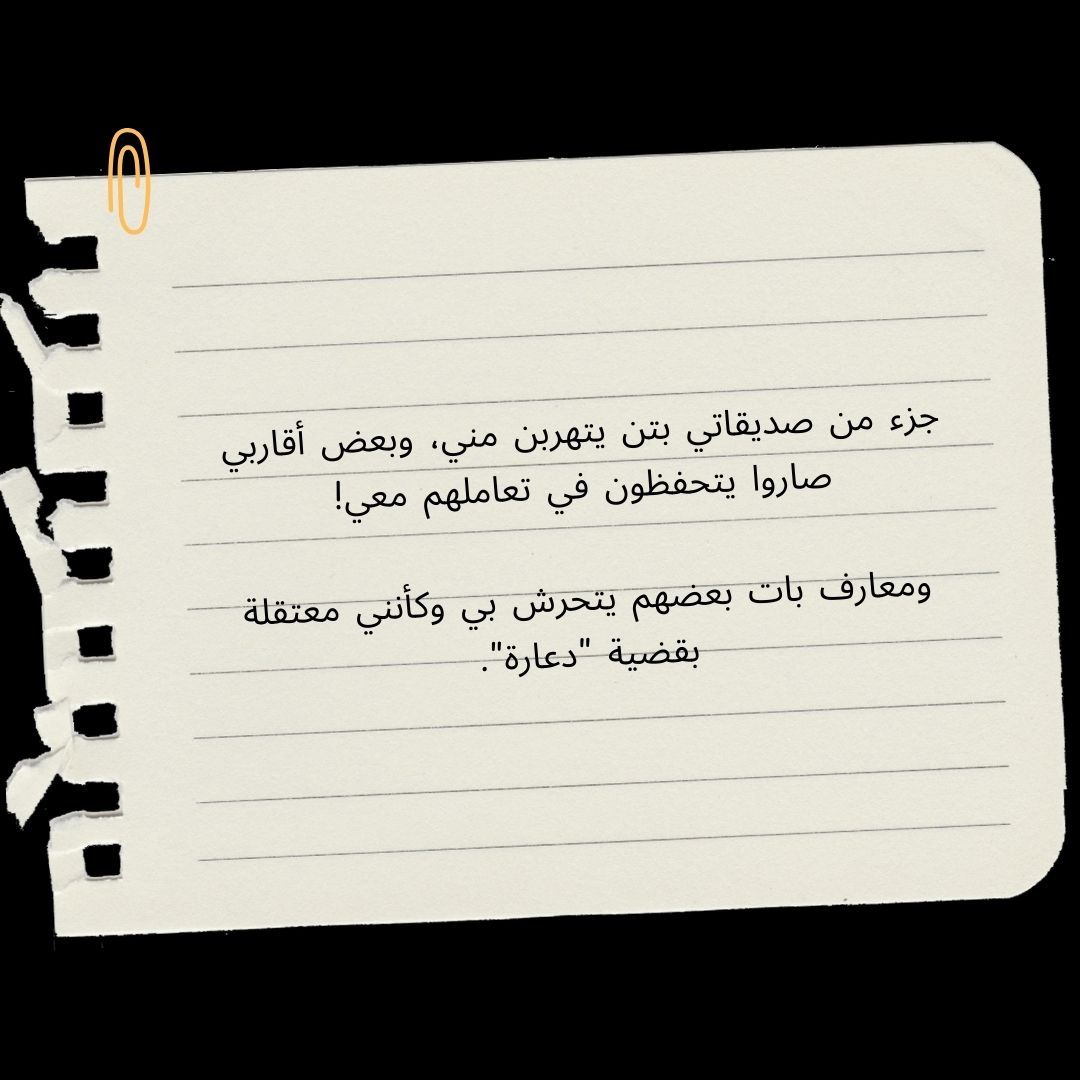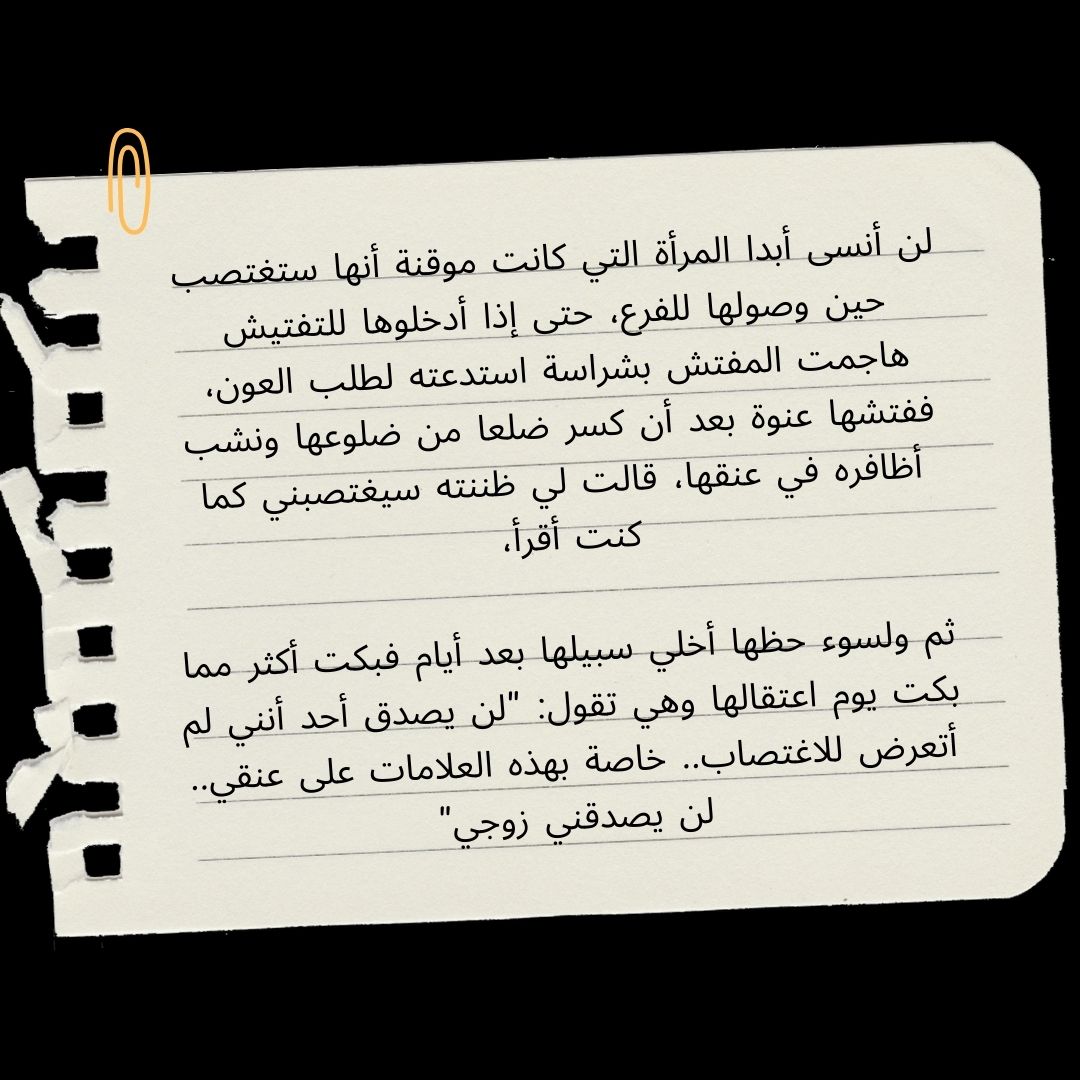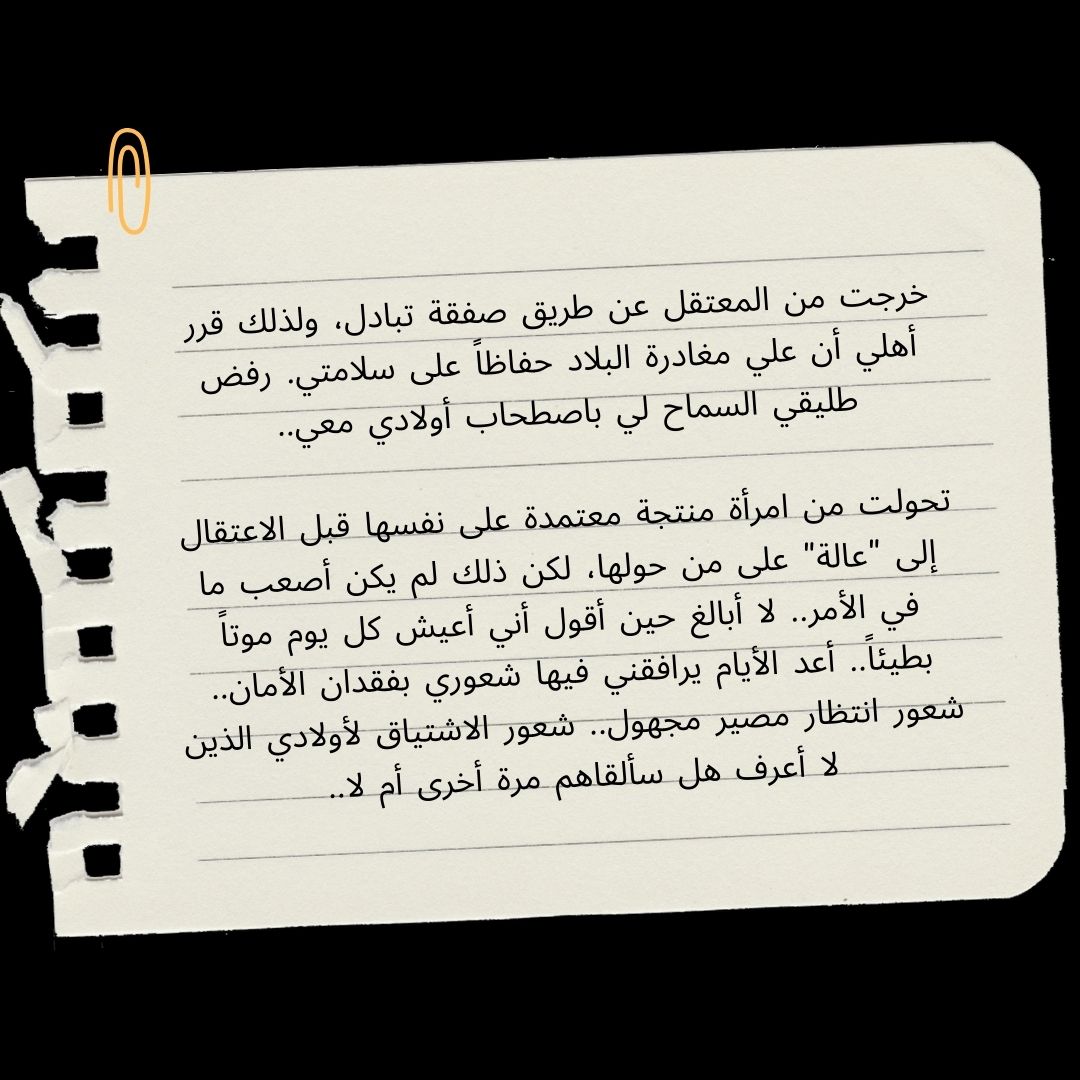تعاملت "أميرة" (مسؤولة منظمة تجمع الناجيات المستقلة بسوريا) مع عشرات الحالات أمثال "آمال". تقول: "رأينا كل أشكال القصص المأسوية لما بعد الخروج، من التبرؤ من الأهل والأصدقاء، والانفصال عن الأزواج، وحتى التهديد.. ولكل قصة تأثيرها علينا".
تنكفئ "أميرة" أمام جهاز الكومبيوتر، تستقبل الرسائل وترد، لتحاول مساعدة الناجيات إما بجهود تطوعية أو تعاون مع منظمات أو تبرعات، لأجل تقديم دعم نفسي والعودة إلى الدراسة وإقامة مشاريع صغيرة لهن. فتوضح "أميرة": "الضغط زاد بعد خروج هذا العدد الكبير بعد تحرير السجون".

انزوت "حنين" عن أعين الجميع مع أولادها ورفضت مقابلة أحد: "من لما طلعت لهلا ما عم أطلع من البيت".
لا تعلم "إن كانت تنتظر معجزة تحدث أم شيئا آخرا لتكسب مالا يمكنها به تغيير سكنها وبدء حياة جديدة مع أسرتها!".
في كل ليلة، تنام وهي تتذكر ذلك الرقم الذي حصلت عليه في السجن وحل محل اسمها، تحاول قتل أفكارها، لتستقر في عقلها فكرة واحدة وهي التركيز على ما تسعى إليه.
بينما، تخفي "شام" جسدها الشاهد على سنوات سجنها، وتذهب إلى جلسات العلاج النفسي عند الطبيبة "ميلانا". فهي منفذها الوحيد بعدما منع أهلها عنها الهاتف وكل وسائل التواصل الاجتماعي.
تدفعها "ميلانا" لتتجاوز. لكن تقاطعها "شام": "هل سأعود إلى دراستي!، هل سأعوض سنوات عمري، ومن الذي يتزوج معتقلة مغتصبة؟، لقد صرت عايبه".
في أغلب المرات، تعجز "ميلانا" عن الرد، فتقول بعدما تغادر "شام" وكل الحالات: "بنهاية اليوم، يكون صدري ثقيلا جدًا. لازال عدد منهم حتى اليوم لما بيحكوا، يخفضن صوتهن، لازال الخوف باقيا داخلهن رغم رحيل النظام، غير تهديد بعض الأهالي".
وتكمل: "دموعي تنزل أكيد وأجففها لأعود إليهن من جديد، والآن أنسق مع عدة جهات لدعم فتح مراكز لمعالجة الناجيات وإعادة دمجهم بالمجتمع وتوثيق الانتهاكات لنقيم دعوات قضائية ونجلب تعويضات".
وبدافع كثير من التعب واليأس، استجابت "آمال" لرغبة أسرتها وسافرت إلى تركيا، "فلا شيء يمكنها البقاء والتحمل لأجله"، كما تقول.
تجلس أمام التلفاز وتتابع الأخبار، ثم تمسك هاتفها، محاولة التواصل مع أبنائها عن بعد لعلهما يأتيان إليها يومًا. تسند رأسها على الوسادة وأثر صعق لا زال جليًا على جبينها، وتقول: "هل سأظل وحيدة بقية حياتي؟ لن أرى أولادي مرة أخرى؟". ولا تخفي في بقية حديثها: "صرت أفكر في الانتحار كل يوم وأعود عنه".
على شاشة التلفاز، ثمة جدل يدور حول حقوق النساء – وهن يشكلن نحو 50% من سكان سوريا- في نسخة البلد الجديدة بعد رفض أحمد الشرع مصافحة وزيرة خارجية ألمانيا، وتعيين شادي الويسي وزيرا للعدل، وهو الذي أشرف على إعدام سيدتين عام 2015.
يتردد هذا النقاش على القناة داخل عيادة الطبيبة "ميلانا"، التي يدق هاتفها، ليأتيها خبر انتحار إحدى السيدات المحررات اللاتي خرجن الشهر الماضي من السجن. تغلق الهاتف ووجهها جامد وتقول بأسٍ: "كل الأدلة الطبية تشير أنها حالة قتل، لكن من المستحيل إثبات ذلك، وسط تعتيم الأهل والمجتمع، وفي مثل هذه الفترة".
على مقربة، حيث مكتب رابطة الناجيات، تتلقى "أميرة" اتصالا أيضًا: "هناك حالة من سجن صيدنايا ومعها ولدين نتيجة اغتصاب، وهي بحاجة إلى المساعدة"، ولما تحركت مع فريق، اختفت السيدة ورفضت مقابلتهم. وما عرفته "أميرة"، أنها "خافت من لقاء أي شخص حتى لا تصل معلومة لأهلها ويقتلوها!".