"الثوار ليسوا على الباب".. كاتبة إيرانية تحلل: ما يحدث ثورة أم إصلاح؟
المظاهرات في إيران
كتبت - رنا أسامة:
"هل الاضطرابات الجارية في إيران والتظاهرات المُندّدة بنظام الرئيس الإصلاحي حسن روحاني، ثورة أم إصلاح؟".. سؤال حاولت الكاتبة الإيرانية "هاليه اسفندياري" الإجابة عليه في مقال تحليلي نشرته مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية.
وانطلقت الكاتبة الإيرانية الأمريكية في تحليلها استنادًا إلى كتاب (الديمقراطية في إيران)، واستهلّت المقال قائلة: "كثيرًا ما بدت إيران وكأنها على شفا الديمقراطية، فخلال القرن العشرين شهدت البلاد 3 اضطرابات سياسية كُبرى: الثورة الدستورية في 1905-1911، وحركة تأميم النفط في 1951-1953، والثورة الإسلامية في 1978-1979".
وأشارت إلى أن "كل واحدة منها كانت مختلفة عن الأخرى ولكن جميعها جاءت كرد فعل على الفساد، وسوء الحكم، والاستبداد. وعكست جميعها تزايد محو الأمية، وتوقّعات الطبقة المتوسطة المتنامية، ونفاد صبر طبقة رجال الأعمال والأثرياء من سوء الإدارة الرسمي. وقد تطلّعت جميعها إلى تطبيق أحد أشكال الحكم الديمقراطي، غير أن هذا الطموح كان يخيب في كل مرة.
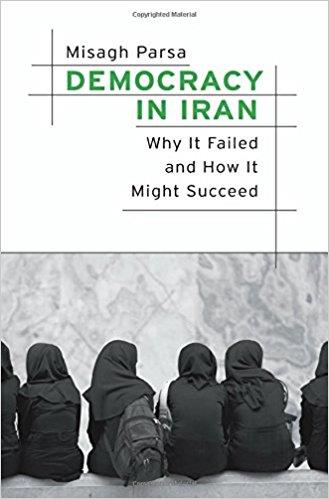
وتابعت اسفندياري: "خلّف دستور عام 1906 برلمانًا منوطًا بالتحقّق من قوة الشاه، وإعطاء الشعب الإيراني حق السيطرة المطلقة على بلده. ولكن بعد عقدين من الزمن عاد الشاه إلى الحكم المطلق مرة أخرى، وتحوّل البرلمان إلى مجرد تابع للشاه، وتم تجاهل الدستور الجديد إلى حد كبير".
وأضافت أن "حركة 1951-1953 تأثّرت بشكل أساسي بطلب تأميم صناعة النفط الإيرانية التي كانت تسيطر عليها الحكومة البريطانية آنذاك. وكان زعيمها، رئيس الوزراء محمد مصدق، شعبيًا، ومُصلحًا، وبطلًا للسلطة البرلمانية، بدلاً من السلطة الملكية. ولكن مرة أخرى، اختفى ما اعتقده البعض صعودًا للديمقراطية عندما تمت الإطاحة بمصدق عام 1953 في انقلاب خططت له وكالة المخابرات المركزية والاستخبارات البريطانية، ومن ثمّ احتفظ الشاه بعرشه، وتبع ذلك حملة ملكية على النشاط السياسي".
وتمضي "اسفندياري" في تحليلها، مُستشهدة بكتاب الباحث في شؤون الشرق الأوسط "ميساج بارسا"، الذي يبحث السر وراء السؤال "لماذا قوى القمع هي صاحبة اليد الطولى دائمًا على النزعات الديمقراطية في إيران، وكيف يمكن أن تظهر الديمقراطية في نهاية المطاف في إيران".
كما يتطرّق بإيجاز للثورة الدستورية وحركة تأميم النفط. ولكنه يُركّز بشكل رئيس على ما يصفه بـ"الوعد الديمقراطي الفاشل للثورة الإسلامية 1978-1979". ويخلُص إلى أنه "بالنظر إلى طابع الجمهورية الإسلامية، فإن الديمقراطية إذا وصلت إلى إيران فإنها ستأتي من خلال الثورة لا بالإصلاح التدريجي".
وبحسب الكتاب، كان من الممكن أن تؤدي الثورة الإسلامية إلى حكومة ديمقراطية. فقد جاءت مدعومة من قِبل ائتلاف واسع: طلاب الثانويات والجامعات، وأصحاب المحال التجارية، والتجار، والمثقفين، والعمال ذوي الياقات الزرقاء والبيضاء. إلى جانب رجال الدين الذين جمعوا حشودًا كبيرة ومتنوعة نقلوها إلى الشوارع.
ولكن حتى أولئك الذين ساروا للثورة تحت راية الإسلام، والذين صوّتوا لاحقًا على إنشاء جمهورية إسلامية، لم يتوقعوا "حكومة دينية متطرفة"، (ثيوقراطية)، يؤسّسها رجال الدين فيما بعد. وقاد زعيم الحركة، آية الله الخميني، الكثيرين إلى الاعتقاد بأنه يؤيد شكلًا من أشكال الحكم الديمقراطي، وأنه ملتزم بحرية الصحافة وحرية التعبير، وليس له مصلحة في حكم البلاد بنفسه أو وجود رجال دين آخرين يديرون الحكومة، وفق الباحث "ميساج بارسا".
ومع ذلك، ترى الكاتبة الإيرانية أن بارسا فشل في نقل إلى أي مدى كان الخميني ملتزمًا بفكرة الدولة الإسلامية التي يرأسها رجال الدين ولا تعطي وزنًا كافيًا لسلطة رجال الدين كهيئة. وإن كان قد أشار إلى بروز الإسلام بشكل كبير في القيم والآراء السياسية للتجار وأصحاب المحال التجارية والطلاب الذين أثبتوا أنفسهم في منابر الجماعات السياسية، مثل حركة حرية إيران، التي دعمت الثورة.
بيد أن الشعار الرئيسي للمتظاهرين "الاستقلال، والحرية، والجمهورية الإسلامية"، لم يذكر الديمقراطية قط. ما يعكس أن الخميني -الذي تلقّى تدريبه، بدون شك، على يد المستشارين العلمانيين الذين تجمّعوا حوله خلال نفيه القصير إلى باريس في عام 1978- كان غير صادق في تأييده للديمقراطية.
الأمر الذي يُناقض ما كتبه الخميني عن الحكومة الإسلامية، خلال فترة نفيه الطويل في العراق عام 1970، في مقاله الشهير الذي أكّد فيه أن "رجال الدين يجب أن يحكموا في دولة إسلامية". وحتى في باريس، أصرّ على أن الشريعة يجب أن تسود في حكومة إسلامية حقيقية. وبعد الإطاحة بالنظام الملكي، صوّت الإيرانيون بأغلبية كبيرة لجمهورية إسلامية صريحة وللدستور الذي وضع رجل الدين، الخميني، في السلطة.
"الحكومة الدينية"
كان محور ولاية الفقيه هو الركيزة الرئيسية للمشروع الثوري، والمُستند إلى فكرة أن "السلطة المطلقة في دولة إسلامية يجب أن تخوّل لأكبر فقيه إسلامي حي، مع تحديد رجال الدين الإطار الأساسي للقوانين، والنظام القضائي، وكيفية حكم البلاد". وترتّب على ذلك، بحسب "بارسا" أن "الخميني وحلفاءه انتقلوا إلى تأسيس حكومة دينية، واعتمدوا على آليات أيديولوجية وسياسية وقمعية لكسب تأييد شعبي وقمع المعارضة المتزايدة". وحتى مع تبنّي الزعيم الجديد لإيران سياسات العدالة التفضيلية لمصلحة الفقراء والمضطهدين، سارع للقضاء على مُنافسيه وإسكات مًعارضيه.
وكما يروي "بارسا": نشر الخميني ومساعدوه في هذه الحملة الشرطة الدينية؛ قوات الحرس الثوري الإسلامي، القوة العسكرية الموازية بجانب الجيش النظامي، المسؤولة عن حماية الطابع الإسلامي الإيراني؛ والبلطجة التي تمارسها جماعة أنصار حزب الله.
وأوقف أعضاء هذه الجماعات التجمعات المنشقة، فيما أغلق النظام الجديد الصحف التي تنتقد النظام الناشئ، وحظر منظمات المعارضة بما في ذلك الحزب الديمقراطي الكردي الذي وصفه الخميني بـ"حزب الشيطان". وكذلك قُتِل مئات الأكراد في مناوشات مع الحرس الثوري أو أعدموا بعد إدانتهم بجرائم مثل "محاربة الله"، أو بعبارة أخرى، (التمرّد).
وفي الوقت نفسه، لاقت حركات أخرى كانت قد أطلقت حملة لصالح الأقليات الإثنية مصيرًا مُماثلًا. وأخيرًا، التف رجال الدين حول الخميني ضد حلفائهم السابقين. ودعمت الجماعات اليسارية الراديكالية، أمثال "مجاهدي خلق"، والأكثر اعتدالًا كما "حرية إيران"، برئاسة مهدي بازرجان، -أول رئيس وزراء للخميني-، في البداية المرشد الأعلى، ولكنهم وجدوا أنفسهم في غضون بضعة أشهر مُستهدفين من قِبل النظام.
وحلّ أبو الحسن بني صدر كأول رئيس للبلاد بعد الثورة. وكان مستقلا حاول رسم مسار معتدل خلال الأزمة التي بدأت في نوفمبر 1979؛ عندما احتجز المتظاهرين 66 أمريكيًا في سفارة واشنطن في طهران (واحتجزوا 52 منهم كرهائن لأكثر من عام)، لكنه، في الوقت نفسه، خاض صراعًا مع كبار رجال الدين، وتمت الإطاحة به من قبل البرلمان في يونيو 1981؛ أي بعد 16 شهرًا فقط من رئاسته.
"وسُرعان ما تبع ذلك حمام دم حقيقي"، هكذا يصف الكتاب انتفاض أتباع بني صدر بعد الإطاحة به، إذ أعدم النظام الديني 2665 شجينًا سياسيًا خلال 6 أشهر. وفي هذا الصدد يقول "بارسا": "حتى أعلى الزعماء الدينيين لم يكونوا مُحصّنين". ولفت في ذلك إلى تهميش آية الله محمود طالقاني، رجل الدين الليبرالي الشعبي. فضلًا عن وضع آية الله العظمى كاظم شريعة مداري، الذي رفض عقيدة ولاية الفقيه، قيد الإقامة الجبرية.

"الإصلاح والقمع"
تلفت اسفندياري، إلى أن الكتاب يُظهِر أن وسيلة القمع ظلت سمة بارزة من سمات الجمهورية الإسلامية منذ ذلك الحين، ولكن في المقابل لم يتم القضاء على المعارضة قط، وظلت أفكار الإصلاح وسيادة القانون والحكومة الديمقراطية الخاضعة للمساءلة موجودة. وكانت هناك دائمًا انشقاقات داخل النخبة الحاكمة.
ويذكر أن الأصوات المخالفة كانت دائمًا ما تثبت نفسها؛ لاسيما في مواضيع مثل قتل السجناء السياسيين، ومنع الصحف، والعبث في الانتخابات. ففي عام 1981، قال أحد أحفاد الخميني لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن الحكومة الإسلامية "أسوأ من حكومة الشاه والمغول"، متهمًا النظام بـ"قتل الناس أو سجنهم بلا سبب".
وكانت هذه الاتجاهات الخفية تُصعّد بين الحين والآخر إلى السطح. في عام 1997 انتخب محمد خاتمي رئيسًا بأغلبية ساحقة، بعد وعود تطرقت إلى زيادة الحريات الاجتماعية والسياسية والصحفية واحترام سيادة القانون وحقوق الخصوصية. وكما يشير "بارسا"، فإن خاتمي لم يكن ثوريًا؛ لم يكن يريد الإطاحة بالجمهورية الإسلامية أو الطعن في أسس النظام، ولكنه حاول تخفيف الضوابط على الصحافة والنشاط السياسي، ومواجهة الأجهزة الأمنية، والنهوض بجدول أعمال اقتصادي موجّه نحو السوق.
ورغم ذلك، فإن "القوى المُحافظة كثّفت تكتيكاتها القمعية، ولم تدم لحظة خاتمي الإصلاحية طويلًا. بدأت ردود الفعل العنيفة عام 1998 مع سلسلة من الانتقام من المعتدلين القياديين. وفي العام نفسه، قُتِل اثنان من الزعماء الإصلاحيين في منزليهما، واكتُشّفت جُثتا اثنين من الكتاب الإصلاحيين في أجزاء مختلفة من طهران. ويعتقد على نطاق واسع أنهما قتلا من قبل الأجهزة الأمنية. كما اعتُقِل عبدالله نوري، وهو رجل دين بارز ووزير داخلية خاتمي، وغلام حسين كرباشي، رئيس بلدية طهران ومؤيد لخاتمي، بعد الحكم عليهما بتهم ملفقة".
في العام التالي، عصف بإيران واحد من أعنف الأحداث في تاريخها الحديث. فبعد أن أُغلِقت الصحيفة ذات الميول الليبرالية "سلام"، في يوليو، اندلعت احتجاجات في جامعة طهران. وقد رد النظام بقسوة، فأرسل قوات الأمن قبل الفجر لضرب التلاميذ في أسرّتهم، ولتخريب أماكن سكنهم.
وقد سبّب الحادث مشكلة بالنسبة للمؤسسة الدينية. وكما يلاحظ الكتاب، فإن عدد الطلاب الجامعيين، في العقدين المنقضيين منذ الثورة، زاد 10 أضعاف تقريبًا، من نحو 160 ألفًا في أوائل الثمانينات إلى 1.5 مليون في عام 2000. وأقليّة منهم فقط كانت تشارك عادة في النشاط السياسي، ولكن لم يستغرق تسييس البقية وقتًا طويلًا.
ومثّلت الاحتجاجات الأوليّة ومظاهر القمع في جامعة طهران الشرارة الأولى، بحسب الكتاب. وخلال الـ6 أيام التالية، انتشرت الاضطرابات في الجامعات والمدن في جميع أنحاء البلاد. ورفع قادة الطلاب سقف مطالبهم، داعين إلى حرية الصحافة، والإفراج عن السجناء السياسيين، ومُساءلة الحكومة. وهتفوا بشعارات على غِرار "يسقط الديكتاتوريين" و"الموت للطُغاة"، ودعوا المرشد الأعلى علي خامنئي إلى الاستقالة.
في البداية، أعرب العديد من كبار رجال الدين والمسؤولين الحكوميين، بمن فيهم خامنئي نفسه، علنًا -على الأقل- عن تعاطفهم ودعمهم الحذر للطلاب، وشجبوا أعمال العنف ضدهم. وسُرعان ما تغيّر الموقف الرسمي بسرعة مع انتشار الاحتجاجات وتزايد جذرية نغمة الاحتجاج، أرسِلت قوات شبه عسكرية من الحرس الثوري لضرب المتظاهرين، واعتُقل عدد كبير منهم فيما اختفى بعضهم ببساطة. وصنف مسؤولون رفيعو المستوى الطلاب كـ"مفتعلي شغب وعصابات".
وفي الوقت الذي انتشرت فيه الاحتجاجات، أرسل 24 من قادة الحرس الثوري رسالة مفتوحة إلى خاتمي يحذرون فيها من أنهم ضاقوا ذرعًا بـ"الديمقراطية" التي كانت تقود إلى "الفوضى". وكانت الرسالة واضحة: "تسامح المؤسسة المحافظة مع المعارضة كان محدودًا للغاية. وإذا تمادت الأحداث أكثر فإنها لن تتردد في استخدام القوة"، حسبما أورد "بارسا".
استمرت هذه الحملة حتى نهاية فترة حكم خاتمي عام 2005. وظهر أنه ليس له سيطرة على قوات الأمن أو أجهزة الاستخبارات أو القضاء أو المحاكم. فجاءت النتيجة، وفق الكتاب، "صعود المحافظين والقمع المكثف".
وفاز المحافظون بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية عام 2004، بعد استبعاد عشرات المرشحين الإصلاحيين من قِبل مجلس الأوصياء. وكان المنتصر في الانتخابات الرئاسية في العام التالي محمود أحمدي نجاد، وهو شعبوي، وبحسب الكتاب، "انتهج سياسات قادت إلى تفاقم الطابع الاستبدادي المتزايد للدولة، وخيبت الآمال في الإصلاح السياسي".
وأضاف: "الرئيس الجديد لم يضيع الوقت في إدخال تغييرات رئيسية، ما يعكس اهتمام الدولة بمزيد من السيطرة والتسييس وعسكرة المجتمع ".
"آمال مُحطّمة"
مع ذلك، يُشير "بارسا" إلى أن إيران شهدت أخطر تحدٍ للمؤسسة المحافظة منذ عام 1979، خلال فترة حكم أحمدي نجاد. ففي عام 2009 ترشح نجاد، الذي تدعمه المؤسسة الحاكمة بما في ذلك المرشد الأعلى وكثير من قادة الحرس الثوري، لولاية ثانية.
وقد تحداه اثنان من السياسيين البارزين هما مير حسين موسوى رئيس الوزراء السابق ومهدى كروبى رجل الدين البارز ورئيس البرلمان السابق. وكلاهما كانا شخصيات مؤسسة، ولكن كلاهما شن حملة من على منصات الإصلاح لوضع حد لعزلة إيران الدولية، وحظيت هذه الرغبة في التغيير بتأييد واسع النطاق.
وعشيّة التصويت أشارت جميع الدلائل -بما في ذك حجم التجمعات المعارضة، وحماس أنصار موسوي، والحضور الكبير في يوم التصويت نفسه- إلى فوز موسوي. ولكن فور إعلان النتائج، في وقت مبكر بشكل يثير الشبهات، بفوز نجاد بهامش واسع على نحو لا يحتمل، اندلعت الاحتجاجات في اليوم التالي.
تدفقت حشود ضخمة إلى شوارع طهران هاتفة "أين صوتي؟". وخلال الأيام التالية، نمت الحركة الخضراء التي أصابت النظام بالذعر، والتي سميت تيمًنًا باللون الذي اعتمده مؤيدو موسوي خلال الحملة، وبدأت تدعو إلى تغيير جذري يتجاوز الإصلاحات المعتدلة التي تبناها زعيما المعارضة.
في المقابل، ردّ النظام على هذه التظاهرات بقسوة، وفي معرض وصف تفاصيل ما حدث، يقول بارسا: "تم إرسال عدد كبير من شرطة مكافحة الشغب والقوات شبه العسكرية إلى الشوارع، فاعتقلوا المتظاهرين وقادة متعاطفين مع حركة الإصلاح. أغلقت الحكومة المنظمات السياسية المعارضة، وحظرت المظاهرات (التي حدثت على أي حال)، وأصدرت وابلًا من الدعايات ضد المتظاهرين. وقُتِل العديد منهم في معارك مع قوات الأمن في الشوارع، أو من قِبل القناصة من على أسطح المنازل".
وأحدثت "الحركة الخضراء" هزّة في أساس الجمهورية الإسلامية أكثر من أي حدث آخر في ثلاثين عامًا منذ الثورة، بحسب بارسا. وانتشرت بسرعة كبيرة على نحو مُشابه لما شهدته المرحلة الأخيرة من ثورة عام 1979.
مع ذلك فإن فشلها، في رأي بارسا، يعود جزئيًا إلى أن قائديها، موسوي وكروبي، كانا يؤمنان بالإصلاح التدريجي، ولم يكونا يطالبان بالتغيير الجذري الذي تسعى إليه الحشود، حتى أن موسوي حاول كبح جماح المتظاهرين في عدة مناسبات. وأدت هذه الفجوة بين القادة والمتظاهرين إلى إضعاف الحملة. علاوة على ذلك، لم يكن لديهما أي خطط للتعامل مع حملة النظام، كما لم يكن المتظاهرون أنفسهم منظّمون بما فيه الكفاية للحفاظ على الحركة في مواجهة الضغط الحكومي.
وفي الوقت نفسه، فشل الزعماء في حشد الفئات الاجتماعية من الطبقة المتوسطة خارج قاعدة المعارضة. ونتيجة لذلك، وخلافًا لثورة 1978-1979، ظلّت الغالبية العظمى من رجال الدين، وخطباء صلاة الجمعة، والتجار، والعمال، خارج الصورة. وعزا "بارسا" ذلك إلى "فشل القيادة، وضعف أو غياب هياكل الدعم مثل النقابات العمالية والجمعيات المهنية، إلى جانب القمع الشديد من قبل النظام".

"النموذج الإندونيسي"
في ضوء الإصلاح الفاشل والاحتجاجات والقمع الذي شهدته إيران منذ أعوام، يحاول "بارسا" الإجابة على السؤال الذي يبدأ به كتابه: "أي طريق يمكن أن تتخذه الديمقراطية في إيران: الإصلاح أو الثورة؟".
وفي هذا الصدد، يُقدّم بارسا نموذجين لبلدين لهما تاريخ ديمقراطي خاص: كوريا الجنوبية وإندونيسيا. ففي الأولى، أنشأ الجيش، بعد انتفاضة طلابية في عام 1960، ديكتاتورية وفرض دستورًا يميز الجيش كنخبة حاكمة. لكنها لم ترفض الديمقراطية من حيث المبدأ أو تحاول القضاء على معارضة الطبقة الوسطى. وفي الوقت المناسب، أعادت القوى المعتدلة تنظيم صفوفها ودفعت مرة أخرى من أجل الإصلاح الديمقراطي.
وعلى النقيض من ذلك، رفضت الديكتاتورية التي أنشأها الجنرال سوهارتو، في إندونيسيا، عام 1967، فكرة الديمقراطية ذاتها، وأغلقت الباب أمام السياسة التنافسية. واستولت الدولة على جزء كبير من الاقتصاد المزدهر بفضل عائدات صناعة تصدير النفط في البلاد. وأعطت الجيش صلاحيات واسعة في السياسة والشؤون الاقتصادية.
وفي عام 1997، قامت ثورة في إندونيسيا بعد عقود من القمع والفساد. في أوائل عام 1998، بدأت الاحتجاجات الجماهيرية وأعمال الشغب. وفي غضون 5 أشهر، دفع سوهارتو ثمن دعم الجيش له، وأُجبِر على تقديم استقالته.
واستنادًا إلى النموذجين، يرى "بارسا" أن "إيران يناسبها النموذج الإندونيسي على أفضل وجه". فالجمهورية الإسلامية هي "دولة استبدادية"، تتركز السلطة في أيدي نخبة ضيقة، وهم رجال الدين. حتى المعارضة الإصلاحية المعتدلة قد استبعدت إلى حد كبير من النفوذ. أيديولوجية الدولة ترفض الديمقراطية من حيث المبدأ، وتتدخل الدولة بشكل مكثف في المجالات الاجتماعية والثقافية؛ ما يضطر السكان إلى مقاومة سلبية أو معارضة صريحة، ويزيد من حدة التوتر بين الحكومة والمجتمع، بحسب قوله.
يقول "بارسا": "رجال الدين الحاكمين ليس لديهم مصلحة في التحول الديمقراطي؛ لأنه سيقوّض امتيازاتهم الاقتصادية وقوتهم السياسية". ويخلُص إلى أن الطريق إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على إيران من خلال الإصلاح "غير متاح" وإذا استمرت هذه الظروف والصراعات، لن يكون أمام الإيرانيين خيارًا لإضفاء الطابع الديمقراطي على نظامهم السياسي سِوى "الثورة".
وبعيدًا عن ترجيح "بارسا" لنشوب ثورة في طهران، تلفت الكاتبة الإيرانية الأمريكية في مقالها إلى أن "العقود الثلاثة الماضية أظهرت مرارًا وتكرارًا أن الشعب الإيراني، بشكل عام، يفضل التغيير السلمي على الاضطرابات، لقد صوّتوا مرتين بأعداد كبيرة للرئيس الإصلاحي خاتمي، وفي الانتخابات الرئاسية الأخيرة اختاروا مُجددًا الإصلاحي المعتدل حسن روحاني.
وكما أشار بارسا إلى بقاء العمال والتجار وأصحاب المحال التجارية والغالبية العظمى من رجال الدين، بعيدين عن الاحتجاجات في عام 2009. تعتقد الكاتبة أن هذا الأمر يُرجّح أن "هذه المجتمعات الرئيسية غير مستعدة لاضطراب آخر من النوع الذي شهدته السنوات الأولى للجمهورية الإسلامية، وأن جروح الماضي من القمع لم تلتئم بعد".
واختتمت مقالها بالقول: "يبدو أن النظام تعلم من تجربته في عام 2009. فقد سمح بانتخاب روحاني في عام 2013 وتجنب التدخل الصارخ في الاقتراع. هذا الحذر من جانب النظام، والاضطراب الذي كان الإيرانيون شهودًا عليه في بلدان الربيع العربي، (مصر وسوريا واليمن)، وفي الدول المجاورة لإيران، أفغانستان والعراق، عزّز تفضيلهم للتغيير من خلال الإصلاح التدريجي، ولتحقيق ذلك اختاروا صندوق الاقتراع، وليس الرصاص.. الثوار ليسوا على البوابة بعد".
فيديو قد يعجبك:









